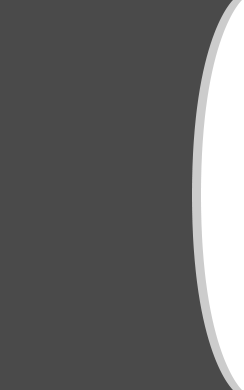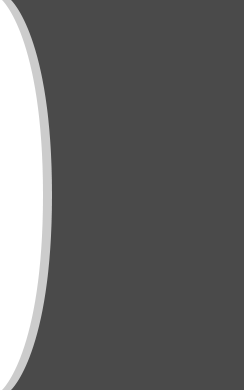كيف يدمر الزعماء الأقوياء العالم؟
على مدار عقود، ومع تجنب المنطقة العربية ونظم الحكم فيها موجات التحول الديمقراطي التي اجتاحت أمريكا اللاتنيية وشرق ووسط أوروبا، ظل حكام المنطقة ورجالهم الأكثر نصيبًا من الوصف بالرجال الأقوياء.
القوة لم تكن تعني بالنسبة لمن يصف (عادة الإعلام الغربي) شيئًا إيجابيًا، فالتشابه بين كل هؤلا الأقوياء أنهم حكام مستبدون، يصلون إلى السلطة دون انتخابات، يقمعون شعوبهم، قادرون على البقاء، ينفردون بكرسي السلطة لعقود، مثلما هم عاجزون عن تحسين ظروف شعوب بلدانهم.
وفي المقابل، ربما لم يتلق هؤلاء الزعماء أو محبيهم أو حتى معارضيهم هذا الوصف بمفهوم سلبي، بل كان الوصف مصدرًا للفخر الوطني لدي الكثيرين. فنحن لدينا حكام أقوياء، وزراء أقوياء، ورجال أمن أقوياء، وخلفاء محتملون أقوياء.
ولم يكن إستثناءً من هذا المنطق حتى بعض من يعارضون الاستبداد في بلدانهم. ففي ظن البض، هؤلاء الحكام قد شاخوا واستبدوا، نعم، لكن مطلوب زعيم قوي بديل.
لم يكن مفهوما ما المغزى من القوة؟ وما الأسباب وراء هذا الهوس والإعجاب بها والرغبة فيها؟ هل هي قوة ضرورية في الداخل؟ لكن في مواجهة من؟ الشعوب! أم هى قوة ضرورية في الخارج؟ ولكن لإثبات ماذا؟ أننا بلدان قوية حتى لو كنا في الحقيقة مجتمعات في غاية الضعف والهشاشة؟!
كانت بداية الألفية كاشفة للحقيقة، وإن لم تستثر تفكير هؤلاء من محبي فكرة "الزعامة" و"القوة" في بلداننا الكثير، بل ربما كان الأمر على العكس.
النزاع في السودان ومجازره وتقسيمه، اجتياح العراق وما تلاه من فوضى، انكشاف نمو وازدهار قيم الرجعية بتنامى نفوذ اإسلام السياسي بشكل واضح للعيان في المنطقة، وعودة نفوذ إرهاب جديد خرج من بلدان يحكمها زعماء أقوياء ليضرب في الخارج، أو تنمو بذوره بوضوح في الداخل (سيناء والداخل السوري مثلا).
ثم مع بداية عام 2011، وخروج احتجاجات الربيع العربي، بدا الأمر أكثر وضوحا لمن يعمل العقل فيما حافظ البعض على رؤية سطحية للواقع، وحالة إنكار لحقيقة أن القوة المزعومةلم تكن سوى قوة إحكام غطاء يخفي تحته مشكلات مدمرة صنعها هؤلاء الأقوياء عن عمد أو فشلوا في التعامل معها فشلا ذريعا ( تطرف، إرهاب، فساد، قبلية)، ومن ثم فهم المسؤلون الرئيسون عنها.
أما عن منطقية القوة وقدرتها على تثبيت حكم مستبد، بدت أنها قوة شكلية على السطح كذلك تخفي أسفلها هشاشة وضعف فرض النفوذ، خاصة أننا نتحدث عن أنظمة اسقطتها احتجاجات في أيام قليلة.
أما الأنظمة التي تم تثبيتها فقد بقيت بدعم خارجي وليس أكثر(فالزعيم القوى المصري والتونسي والليبي واليمني ) رحل مثلما رحل من قبل الزعيم العراقي بعد الغزو الأمريكي للعراق، وبقي الزعيم السوري القوي لحسابات إقليمية ودولية معقدة وليس أكثر، جزء رئيسي منها أن هناك زعيما قويا آخر (بوتين) تدخل لإنقاذه، ثلما تدخل لإثبات قوته في أوكرانيا فأصبحت بلاده في أزمةإقتصادية ، حيث دهورت قيمة الروبل وخسائر اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات سنويا بسبب عقوبات دولية.
عمليا لم تكن تلك التجربة الممتدة من 2003 إلى 2011 بديناميكياتها القوية كافية لإثبات شيء حول عدم صلاحية فكرة "الزعيم القوى" كمنطق للحكم أو إعادة تشكيل الوعي حول الخصائص المطلوبة في النظام السياسي الناجح والمرن والكفء وأهمية المؤسسية والديمقراطية والحرية والتنمية مثلما بنت النظم الغربية مجدها، بل ظل الأمر لدى البعض أن هناك من تآمر على هؤلاء الزعماء الأقوياء، فصدام كان ضحية مؤامرة، مثلما كان بن على ومبارك والقذافي، مثلما كان البشير وبشار مستهدفان بمؤامرة. ومن ثم فقد عاد البحث عن الزعماء الأقوياء في منطقتنا، فانتخب المصريون زعيما قويا، وعاد الكثير من السوريين يفكرون في أهمية تثبيت زعيمهم القوي، وبدأ كثير من الليبيون يبحثون عن زعيم قوي هم أيضا.
المنطق ذاته تجده لدى كثير من الإسلاميين الذي كانوا هم أنفسهم ضحية الزعيم القوى في أوقات مثلما كانوا حلفاءه في أوقات أخرى.
فالتجربة الديمقراطية التونسية لا تعجب كثيرا من هؤلاء، بل هناك تجربة أنجح وفق وجهة نظرهم، تجربة أردوغان.
هذا الزيم التركي القوى، الذي يخوض حربا ضد مواطنيه من الأكراد، ويتدخل بشكل استماري في بلدان مثل سوريا والعراق، يفصل عشرات الآلاف من معارضية، ويعتقل مثلهم.
تتدهور عملة بلاده التي تعاني تداعيات اقتصادية كبرى هي الأخرى بسبب أعباء حرب الخارج والداخل. لكن هذا لا يهم، فهو زعيم قوي بنكهة إسلامية، يقدم صورة نقيضة للزعيم القومي الذي كرهه الإسلاميون!
غير أن ما انتجناه في منطقتنا من كوراث مدمرة في عهد الزعماء الأقوياء ولازلنا ننتجه لم يتوقف عند حدودنا، بل يمكن القول إنه الشيء الوحيد الفاعل الذي نجحت تلك المنطقة في تصديره للارج،و هو الرعب وشعور بالخطر من جيل جديد من الإرهاب أكثر شراسة ودموية، وقضية الهجرة التي تم أمننتها.
وبالتوازي مع هذا كان قصور النظام الاقتصادي العالمي الذي لم يتم التصدي له قد راكم آثاره الاجتماعية حتى في المجتمعات المتقدمة. وهكذا بدا أننا لسنا وحدنا فقط من نبحث عن زعماء أقوياء وقت الأزمة، ففرنسا بحثت عن ماري لوبان كزعيمة قوية، وبريطانيا لبت نداء النموذج ذاته باستفتاء البريكست، وإيطاليا وغيرهم ، والأهم أمريكا التى تربع على عرشها "رجل قوى"، هكذا يميل إلى وصف نفسه، ويحب أن يبدو، وقد انتخب على أساس ميوله السلطوية وموقفه الواضح من ازدراء كل ما هو مؤسسي وديمقراطي وتعددي، وخطاب سياسي حنجوري شعبوي، وتقدير وأعجاب بـ"الزعماء الأقوياء" المستبدين في كل منطقة من العالم، ويجد فيهم شركاء حقيقيين. لكن ماذا يفعل الزعيم القوى الأمريكي؟
بحكم وضع أمريكا مقارنة بأوضاع بلداننا وتاثيرها ، فالقوة التدميرية لزعيمها هي أضعاف مضاعفة للقوة التدميرية لزعمائنا الأقوياء، لأنه ببساطة لا يهدم المؤسسية في بلاده ويحارب تنوعا كان عنصرًا رئيسيا في تقدمها ونهضتها، لكنه يهدم قيم وأسس مؤسسية ونظام عالمي ظلت أمريكا فاعلا رئيسيا في القيام عليه لعقود.
وهو نظام وإن شابه القصور كما قلنا لكنه في الحقيقة -ومثلما استفادت منه أمريكا- استفادت من رصه بلدان نامية في بناء قوتها (جنوب شرق آسيا نموذجا). وما يجعل القوة التدميرية للزعيم الأمريكي أسرع هي تحالفات ودعمه لأقرانه من "الزعماء الأقوياء" في مناطق العالم المختلفة ومكافئته لهم على تلك القوة، وتقديره لما يحملونه من قيم.
وبينما قد تكون نتائج صعود زعماء أقوياء لسدة الحكم في بلدان غربية فرصة لإعادة التقييم لدي الشعوب حول اختياراتها، يبدو الأمر لدي الكثيرون في بلداننا كما هو ثابت. فمن ناحية هناك غياب أدوات تداول السلطة، ومن ناحية أخرى لازال البعض مولع بمبدأ الزعيم القوى، متشبثا ومتمسكا به، مقتنعا بانتصاراته الزائفة في خطبه وشاراته القومية الرنانة، ودعايته وما يعيش عليه من بروباجندا، وتقديره للقسم والعلم والأناشيد أكثر من تقديره للفرد ودوره وقميته وحياته.
ولا أعلم إلى أي مدى ما نعانيه وما هو مشرف عليه العالم كاف لدى هؤلاء في بلداننا لإعادة التقييم والتعلم أو إدراك مدى تدميرية المبدأ قوميا كان أم إسلاميا.